يتناول هذا المنشور البنية الهرمية السائدة في الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات في تونس، مُجادلاً بأن هذه التنظيمات غالبًا ما تتمحور حول أفراد ومصالحهم الشخصية بدلًا من الأهداف الجماعية. من خلال إعطاء الأولوية للولاء على حساب الكفاءة والمشاريع الشخصية على حساب التطور المؤسساتي، تُرسّخ هذه الهياكل ثقافة التبعيّة وتقوّض تحقيق الديمقراطية في تونس. يُبرز المنشور الجذور التاريخية والتداعيات السياسية لهذه النماذج التنظيمية، ويختتم بتقديم توصيات تهدف إلى إصلاح الثقافة التنظيمية بما يعزز المساءلة، الشمولية، والقدرة على الصمود في المشهد السياسي والمجتمع المدني التونسي.
المقدمة
كانت انتفاضة تونس في عامي 2010 و2011 نقطة مفصلية في تاريخ البلاد، حيث وعدت بإنهاء عقود من الاستبداد وبدء عهد جديد من الديمقراطية والشفافية. ومع ذلك، وبعد أكثر من عقد من الزمن، لا تزال المنظمات السياسية والمدنية في تونس تعاني من هياكل هرمية تُركز على الأفراد وشبكات المصالح الخاصة، مما يعيق التجديد والابتكار، ويكبت الاختلافات، ويُعلي من شأن الولاء الشخصي على حساب العمل الجماعي. يرى هذا المنشور أن البنية الهرمية للمنظمات التونسية ليست مجرد عيب تنظيمي، بل هي مشكلة سياسية ذات تداعيات عميقة على الحوكمة، الديمقراطية، والتطور المجتمعي في البلاد.
الجذور التاريخية للهياكل الهرمية
تعود البنية الهرمية للتنظيمات التونسية إلى جذور عميقة في التاريخ السياسي للبلاد. في عهدي الرئيسين حبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، تم تركيز السلطة في يد زعيم واحد، وصُممت المؤسسات السياسية لخدمة مصالح النخبة الحاكمة. تبيّن هيبو (2006) كيف استخدمت الدولة التونسية في عهد بن علي القمع والتحكم الاقتصادي للحفاظ على الطاعة، مما خلق نظامًا تتدفق فيه السلطة والامتيازات من الأعلى إلى الأسفل. ترك هذا الإرث الاستبدادي بصمة دائمة على الثقافة التنظيمية في تونس، حيث غالبًا ما يُعطى الأولوية للولاء للأفراد على حساب الالتزام بالأهداف المؤسساتية.
يُفصّل كامو وجيسر (2003) هذه الديناميكية، مشيرين إلى أن “متلازمة الاستبداد” في تونس كانت متجذرة في مركزة السلطة واستقطاب النخب عبر المحسوبية. حتى بعد انتفاضة 2011/2010، التي سعت إلى تفكيك النظام القديم، استمرت العديد من المنظمات – بما في ذلك الأحزاب السياسية والجمعيات الجديدة – في تكرار نفس النماذج الهرمية. وهذا يشير إلى أن المشكلة ليست هيكلية فحسب، بل ثقافية، تعكس قواعد متجذرة للتسلط في المجتمع التونسي.
التداعيات السياسية للتنظيمات الهرمية
إن استمرارية الهياكل الهرمية في التنظيمات السياسية والمدنية في تونس تحمل تداعيات سياسية حرجة، أبرزها:
- تركيز السلطة: من خلال تركيز صنع القرار حول فرد واحد، تُركّز هذه الهياكل السلطة في أيدي القلة، مما يخلق فرصًا للفساد واستغلال السلطة. ويقوّض ذلك المبادئ الأساسية للشفافية والمساءلة التي تعد ضرورية للحوكمة الديمقراطية.
- تآكل الجدارة: عندما يصبح الولاء للزعيم المعيار الأساسي للترقية، يتم تهميش الكفاءة والخبرة. وهذا لا يضعف فاعلية التنظيمات فحسب، بل يعيق أيضًا مشاركة الأفراد الموهوبين في الأنشطة السياسية والمدنية.
- هشاشة المؤسسات: التنظيمات التي تعتمد بشكل كبير على زعيم واحد تكون عرضة للانهيار عندما يغادر هذا الزعيم أو يسقط من موقعه. تقوّض هذه الهشاشة استدامة المؤسسات الديمقراطية في تونس وتحد من قدرتها على قيادة التغيير على المدى الطويل.
- إعاقة الابتكار والمعارضة: التركيز على الولاء للأفراد يكمّم التفكير النقدي ويقيد الابتكار، حيث يُتوقع من الأعضاء الالتزام برؤية الزعيم بدلاً من المساهمة بأفكارهم الخاصة. وهذا يخلق غرف صدى تُعيق التقدم وتعزز الممارسات التقليدية.
يجادل ليفيتسكي وواي (2010) بأن الأنظمة الاستبدادية التنافسية تعتمد على مزيج من القمع والاستقطاب للحفاظ على السيطرة، وهي ديناميكية واضحة في التنظيمات الهرمية في تونس. كما يؤكد كيتشيلت وويلكنسون (2007) على دور علاقات المحسوبية في تشكيل السلوك السياسي داخل هذه الهياكل.
الأحزاب السياسية، النقابات، والمنظمات غير الحكومية
لتوضيح هذه الديناميكيات، تقدم الورقة دراسة لثلاثة أنواع من المنظمات:
- الأحزاب السياسية: العديد من الأحزاب السياسية التونسية، سواء القديمة أو الجديدة، تُبنى حول قادة كاريزماتيين يهيمنون على صنع القرار ويُهمّشون الأصوات المخالفة، مما يؤدي إلى انقسامات داخلية، منصات حزبية ضعيفة، وغياب أجندات سياسية واضحة.
- النقابات: الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي كان في السابق قوة تغيير تاريخية، يعاني أيضًا من هيكل هرمي يعتمد على الولاءات الشخصية، مما أضعف قدرته على تمثيل المصالح المتنوعة لقواعده وأدى إلى الأزمة الحالية التي يواجهها.
- الجمعيات: حتى في قطاع الجمعيات، الذي يُعتبر عادة من أبرز تجليات المجتمع المدني، نجد أن العديد من التنظيمات تتمحور حول أفراد يستخدمون مناصبهم لتعزيز أجندات شخصية بدلًا من الأهداف الجماعية.
تُظهر هذه الأمثلة مدى انتشار الهياكل الهرمية وتأثيرها السلبي على المشهد السياسي والمدني في تونس.
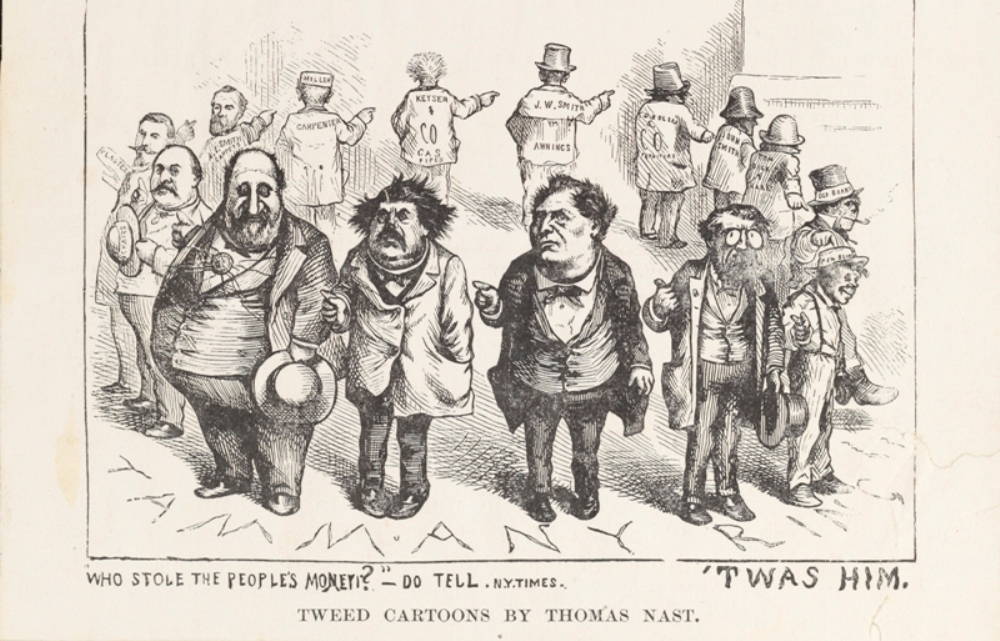
أزمة ديمقراطية
تُشكّل استمرارية الهياكل التنظيمية الهرمية تحديًا جادًا للديمقراطية في تونس. من خلال تعزيز ثقافة التبعية والولاء الشخصي، تُقوّض هذه الهياكل بناء مؤسسات قوية وشاملة تساهم في تعزيز الديمقراطية. كما أنها تُعرّض العلاقة بين القادة والمواطنين للخطر، مما يُغذي الإحباط ويضعف الثقة في التنظيمات السياسية والمدنية.
كشف العقد الذي تلى الانتفاضة عن نقاط الضعف في هذه الهياكل، مما وضع تحديات كبيرة أمام تحقيق ديمقراطية حقيقية. إن إرث مركزة السلطة والضعف الهيكلي لهذه التنظيمات السياسية والنقابية والمدنية أعاق جهود بناء نظام سياسي أكثر شمولية ومساءلة. تجسّد هذه الأزمة في انخفاض نسبة المشاركة الانتخابية واللامبالاة تجاه الأحزاب السياسية. إذا أرادت تونس تعزيز مكاسبها الديمقراطية، يجب أن تُعالج العوامل الهيكلية والثقافية التي تكرّس هذه التنظيمات الهرمية.
توصيات للإصلاح
لتجاوز هذه التحديات، تقدم الورقة التوصيات التالية:
- تعزيز الديمقراطية الداخلية: ينبغي على المنظمات أن تتبنى آليات صنع قرار شفافة ومشاركة، ما يعزز تمكين الأعضاء ويقلل من الاعتماد على القادة الفرديين.
- تعزيز الأطر المؤسساتية: يجب إدخال إصلاحات قانونية وتنظيمية تشجع على المساءلة والشفافية داخل الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات.
- تشجيع الجدارة: يجب أن تركز المنظمات على الكفاءة والخبرة بدلاً من الولاء الشخصي، ما يخلق فرصًا للأفراد الموهوبين لتحقيق التقدم المستدام.
إن تنفيذ هذه الإصلاحات بشكل فعال يمكن أن يساعد في تجاوز أزمة التطور المؤسساتي، ويبني ديمقراطية أكثر قدرة على الصمود أمام التحديات المستقبلية.
الخاتمة
إن الهيكل الهرمي للتنظيمات التونسية هو إرث من الماضي الاستبدادي، ولكن استمراريته في مرحلة ما بعد الانتفاضة يُشكل تهديدًا حقيقيًا للمستقبل الديمقراطي لتونس. من خلال إعطاء الأولوية للولاء الشخصي على حساب العمل الجماعي، والمصالح الفردية على حساب التطور المؤسساتي، تُقوّض هذه الهياكل مبادئ الشفافية والمساءلة والشمولية التي تعتبر ضرورية لنجاح الديمقراطية. معالجة هذا التحدي تتطلب إصلاحات هيكلية عميقة، بالإضافة إلى تحول ثقافي يعزز الجدارة والابتكار والعمل الجماعي. فقط من خلال ذلك يمكن لتونس بناء مؤسسات ديمقراطية حقيقية قادرة على إعادة بناء الثقة في العمل الحزبي والنقابي والجمعياتي.
القرار الحرّ،
الولاء للوطن، السيادة للشعب.
المراجع
- Hibou, B. (2006). La force de l’obéissance: Économie politique de la répression en Tunisie. Paris: La Découverte.
- Camau, M., & Geisser, V. (2003). Le syndrome autoritaire: Politique en Tunisie de Bourguiba à Ben Ali. Paris: Presse de Sciences Po.
- Levitsky, S., & Way, L. (2010). Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes after the Cold War. Cambridge: Cambridge University Press.
- Eisenstadt, S. N. (1973). Traditional Patrimonialism and Modern Neopatrimonialism. Beverly Hills: Sage Publications.
- Weber, M. (1947). The Theory of Social and Economic Organization. New York: Free Press.
- Kitschelt, H., & Wilkinson, S. I. (2007). Patrons, Clients, and Policies: Patterns of Democratic Accountability and Political Competition. Cambridge: Cambridge University Press.

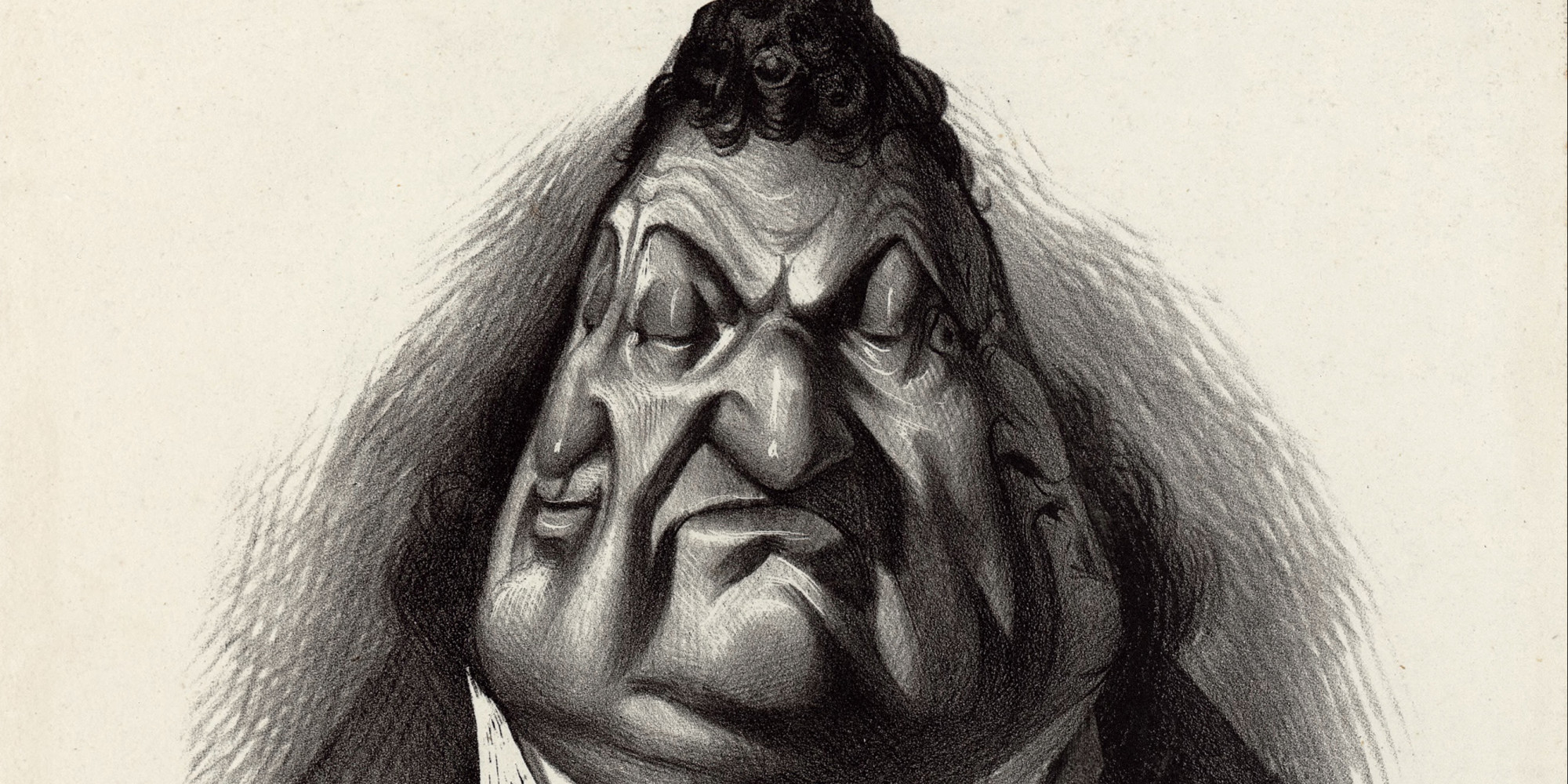
اترك تعليقاً